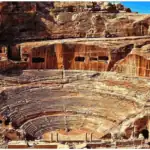مملكة الأنباط الأردنية، جزء: ٦ – ملوك الأنباط ٢
الحارث الثالث هو أحد أبرز ملوك الأنباط الذين أسهموا في توسيع نفوذ دولتهم في القرن الأول قبل الميلاد. تميز عهده بسياسات توسعية، حيث ضم دمشق إلى حكمه وخاض صراعات مع الحشمونيين في يهودا، مما جعله لاعبًا رئيسيًا في التوازنات الإقليمية آنذاك. كما واجه النفوذ الروماني بحذر، محاولًا حماية استقلال مملكته من التبعية المباشرة لهم

الممر الضيق (السيق) المؤدي إلى البتراء
الحارث الثالث (٨٧ – ٦٢ ق.م)
هو ابن حارثة الثاني، ويعتبر بعض المؤرخين الحارث الثالث المؤسس الحقيقي لقوة الأنباط، وقد جنى ثمار الانتصار الذي حققه سلفه ضد أنطيوخس، حيث خلت المنطقة المجاورة له من تدخل اليونانيين (السلوقيين) بشكل مؤقت، مما مكنه من المضي قدمًا في السياسة التوسعية للدولة النبطية. وتوفرت له الفرصة عندما عرض عليه أهل دمشق أن تصبح مدينتهم تحت حكمه، بعد أن سئموا من النزاعات اليونانية الداخلية ورغبوا في التخلص من تحرشات اليتوريين (وهم عرب حكموا منطقة لبنان الشرقي). فدخلت جيوش حارثة المدينة، وظلت تابعة للدولة النبطية لمدة تقارب الخمسة عشر عامًا، مع وجود حاكم مقيم يمثل حارثة. كما ضرب سلسلة من العملات النبطية لتخليد دخول المدينة في حكمه، ويعتقد أن ذلك كان في عام ٨٥ ق.م.، رغم أن هذه العملات استمرت تحمل الشعار السلوقي باليونانية بدلًا من الآرامية. وكانت تلك العملات هي الأولى التي يظهر عليها اسم الملك النبطي وصورته، حيث أضاف حارثة إلى اسمه عبارة “محب يونان”. واستمرت تلك النقود تصدر حتى عام ٧٠ ق.م، عندما انتزعت المدينة من أيدي الأنباط على يد تغرانس دكران ملك أرمينيا
بعد ضم دمشق، وهو مكسب لم يكن يتوقعه، توجه الحارث الثالث نحو عدوه القديم ينايوس (ملك الحشمونيين الذين حكموا مملكة يهودا)، فهاجمه عام ٨٢ ق.م وهزمه في موقع يعرف بحديده شرق يافا، ثم انسحب بعد الاتفاق معه على شروط معينة لكن ينايوس رد الهجوم، فاجتاح شرقي الأردن وانتزع ١٢ قرية من سيطرة الحارث، مما أدى إلى فصل دمشق عن باقي أراضي الدولة النبطية في الجنوب
وفي عام ٧٦ ق.م، توفي ينايوس بعد معاناة استمرت ثلاث سنوات بسبب مرض يشبه الملاريا، أصابه نتيجة الإفراط في الشراب تولت زوجته ألكسندرا الوصاية على ولديها زعماء المكابيين من أسرة جانيوس هيركانوس وأرسطوبولس، والمكابيين هم عائلة يهودية قادت ثورة ضد الحكم السلوقي في القرن الثاني قبل الميلاد، وأسسوا سلالة الحشمونيين التي حكمت اليهودية (يهودا) لعدة عقود، اللذين تنافسا على العرش، هيركانوس باعتباره الابن الأكبر، وأرسطوبولس لما كان يتمتع به من قوة وشجاعة ورغم خضوع ألكسندرا لتوجيهات الفريسيين المتشددين في تطبيق الشريعة الموسوية، تمكنت من إدارة شؤون الحكم بكفاءة
لكن ظهور دكران تغرانس الأرميني هدد توازن القوى في سوريا، ما أجبر الحارث الثالث على الانسحاب من دمشق كما خشيت ألكسندرا أن تصبح اليهودية هدفًا له، فأرسلت إليه الهدايا مع سفراء طلبوا منه التعامل برفق مع ولايتها تقبل دكران الهدايا ووعد بمعاملة الملكة وشعبها بلطف
استولى دكران تفرانس على سك العملة في دمشق من الأنباط، لكنه غادر المدينة عندما علم أن قائدًا رومانيًا من جيش بومبي بدأ بمهاجمة مملكته. الأنباط لم يسع لاستعادة دمشق، فسقطت في أيدي اليطوريين بقيادة بطلميوس بن معن، فحاولت الملكة ألكسندرا الدفاع عن المدينة لكنها فشلت، وبعد وفاتها عام ٦٧ ق.م اندلع صراع بين ابنيها، انتهى بهزيمة الابن الأكبر في معركة بأريحا، مما دفعه إلى التنازل عن السلطة لأخيه واللجوء إلى الحارث الثالث في البتراء
كان أنتيباتر، حاكم إدوم وصديق الحارث، يحرضه على إعادة هيركانوس إلى الحكم فشجع الحارث ذلك، ليس بدافع العدل، بل بوعد هيركانوس بإعادة الاثنتي عشرة قرية التي كان ينايوس قد استولى عليها، مثل مادبا، نبلو، زعر، وأوربه، الواقعة غرب هضبة موآب
زحف الحارث إلى اليهودية (يهودا) وحاصر القدس، لكن مع وصول الجيوش الرومانية بقيادة بومبي إلى سوريا، انسحب دكران من دمشق، وتقدم جزء من الجيش الروماني بقيادة سقاورس إلى اليهودية (يهودا) فسارع الطرفان المتحاربان، الأنباط واليهود، إلى تقديم مطالبهم للقائد الروماني، في محاولة لكسب دعمه. بعد الاستماع إلى شكاوى الطرفين وموازنتها مع قيمة الرشاوى، قرر سقاورس دعم أرسطوبولس، فأمر حارثة بالعودة بجيشه وتجنب استعداء الرومان، حذر سقاورس حارثة من أن استمرار دعمه لهيركانوس دون العودة إلى بترا سيؤدي إلى غزو روماني وشيك. امتثل حارثة للإنذار وانسحب، لكن أرسطوبولس، مدفوعًا برغبته في الانتقام، طارده وهاجم جيشه، مما أسفر عن مقتل ستة آلاف جندي
في عام ٦٤ ق.م، ظهر بومبي في سوريا وبدأ بإعادة تنظيمها كولاية رومانية في العام التالي، وقرر تقييم الأوضاع في بلاد الأنباط، وهناك اختلاف في الروايات حول ما حدث لاحقًا يدعي المؤرخ ديو كاسيوس أن بومبي غزا المنطقة بسهولة وفرض سيطرته عليها، بينما يشير المؤرخ أبيان إلى أن بومبي دخل المدينة بعد هزيمة أتباع أرسطو بولس وسلمها لهيركانوس قبل عودته إلى روما، تاركًا سوريا تحت حكم سقاورس
لاحقًا، قاد سقاورس حملة ضد الدولة النبطية، ويعتقد أنها جاءت استكمالًا لسياسة بومبي أو بدافع الحصول على المال، انتهى الصراع عندما دفع حارثة ثلاثمائة طالن للقائد الروماني ليجنب بلاده الدمار. لعب أنتباتر، والي إدوم، دور الوسيط في هذه الصفقة، حيث أقنع حارثة بالاتفاق، ما أدى إلى وقف الحملة الرومانية
باختصار، عندما دفع حارثة المبلغ، كان يهدف إلى حماية بلاده من التخريب، لكن روما اعتبرت ذلك نوعًا من التبعية الضمنية، خاصة مع امتناعه عن مقاومة الجيش الروماني قبل وصوله إلى البتراء. أما الأنباط، فقد رأوا أن تقديم المال لا يمس سيادتهم، خاصة في ظل السيطرة الرومانية على سوريا
لم يقم بومبي بشن حرب فعلية ضد الأنباط، بل يبدو أنه كان يسعى لتنظيم الأوضاع هناك. إلا أن اضطراب أرسطوبولس وتسرعه في انتظار القرار الروماني بشأن القدس دفعاه إلى صرف النظر عن ذلك. وأثناء وجوده في دمشق، استقبل بومبي وفودًا يهودية تمثل كلًا من هيركانوس، وأرسطوبولس، والشعب اليهودي، حيث اعترض هيركانوس على استيلاء أخيه على الحكم، بينما برر أرسطوبولس موقفه مستندًا إلى ضعف هيركانوس، في حين طالب ممثلو الشعب بإلغاء النظام الملكي
قرر بومبي البت في الأمر بعد عودته من بلاد الأنباط، مما أثار غضب أرسطوبولس، الذي انسحب، مما أثار شكوك بومبي. عند اقترابه من القدس، استسلم أرسطوبولس، وقدم الهدايا، ووعد بتسليم المدينة، لكن السكان رفضوا فتح الأبواب، مما دفع بومبي إلى اعتقاله واقتحام القدس بعد انتصار أنصار هيركانوس
في وقت لاحق، سعى سكاوروس إلى تخليد حملته ضد الأنباط من خلال إصدار نقد يصور حارثة راكعًا بجوار جمل، وهو يقدم غصن زيتون للقائد الروماني، في إشارة إلى الخضوع
عبادة الثاني (٣٠ – ٩ ق.م)
تصوره الروايات التاريخية كشخص كسول ضعيف الهمة ، وتذكر أنه لم يكن يهتم بالشؤون العامة أو العسكرية (استرابو). قد يكون في هذا بعض الحقيقة، لكن المقارنة بينه وبين وزيره الشاب النشيط، الذكي، والجذاب، سيلّايُس، جعلت صورته تتضاءل. فقد كان الوزير، الذي لقب في النقوش بـ”أخ الملك” – وهو تعبير مجازي يعني أنه اليد اليمنى للملك – يمثل في نظر العالم الخارجي الرجل القوي والمسؤول، مما جعله يتصدر الأحداث بدلاً من عبادة نفسه
وعلى الرغم من ضآلة الدور المنسوب إلى عبادة، فإن هناك نقشًا يشير إلى أنه قد تم تأليهه في عهد خليفته. لا يوجد سبب واضح لهذا التأليه، إذ لم يقم عبادة بأعمال تبرر هذا التكريم المبالغ فيه. لكن ربما كان ذلك محاولة من خليفته لترسيخ هيبة ملك الأنباط وإضفاء هالة قدسية على الحكم، بحيث يصبح التأليه تقليدًا يمنح الملوك مكانة خاصة بعد وفاتهم
قد يكون تأليه عبادة مرتبطًا برغبة في إعادة الاحترام إليه، خاصة بعدما طغى نفوذ وزيره سيلّايُس على حكمه، حتى بدا الأمر وكأن الملك كان تحت وصايته. لا يمكننا إنكار حدوث هذا التأليه، إذ هناك دلائل عدة تشير إليه: فأسطفانس البيزنطي يذكر أن “عبدة”، المكان الذي دفن فيه الملك، كان موقعًا لعبادته من قبل الأنباط. كما تمكن الباحثون الدومنيكان يوسن، سافيناك وفنسنت من إعادة رسم مخطط لضريح غريب الشكل، وجدت عليه نقوش نبطية تقول: “عاش عبادة”، بل وظهرت جماعة في البتراء تتعبد له كإله
وفي عام ٢٠ ب.م، تم بناء معبد حجري تكريمًا له، ووضع فيه تمثال. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل أصبح تأليه الملوك تقليدًا متبعًا لدى الأنباط، أم أن الأمر اقتصر على عبادة وحده؟
من أبرز الأحداث التي ارتبطت بالدولة النبطية في عهد الملك عبادة كانت الحملة الرومانية على جنوب الجزيرة العربية، بقيادة غالس في عام ٢٥ / ٢٤ ق.م. وقد هدفت هذه الحملة إلى استغلال الثروات السبئية، سواء عبر تكوين تحالف مع حليف ثري أو فرض السيطرة على عدو غني. وبصياغة أخرى، سعى الرومان إلى التواصل المباشر مع أصحاب التجارة الكبرى، وليس مجرد التعامل مع الوسطاء الأنباط، بل أرادوا أن يصبحوا شركاء فيها، سواء بالطرق السلمية أو بالقوة
وقد ارتبط الأنباط بهذه الحملة من جوانب متعددة، فمن ناحية، عبرت الحملة أراضيهم أو أراضي موالية لهم، حيث تم نقل الجنود من مصر بحرًا إلى ميناء حوارة (ليوقه قومه) في الحجاز. ومن ناحية أخرى، كان دليل الحملة الوزير النبطي سلي، الذي قاد الرومان إلى منطقة الجوف باليمن. كما أن غالس ورجاله حلّوا ضيوفًا لعدة أيام على أحد سراة الأنباط، وهو قريب للملك يحمل اسم حارثة. بالإضافة إلى ذلك، قدم الأنباط دعمًا عسكريًا للحملة بفرقة مكونة من ألف رجل من جنودهم
لكن الحملة انتهت بالفشل، كما ورد في روايات المؤرخ استرابو، الذي كان صديقًا لغالس. وقد حاول استرابو تحميل المسؤولية كاملةً للوزير سلي، متهمًا إياه بالخداع والتضليل. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن سلي كان مخلصًا في مهمته. وإذا تجاوزنا تفاصيل الحملة والصعوبات التي واجهتها، يبقى السؤال المطروح: لماذا قدم الأنباط المساعدة لحملة رومانية قد تؤدي إلى سيطرة الرومان – بدلاً منهم – على مفاتيح تجارة الهند وجنوب الجزيرة العربية؟ ولماذا وافق سلي على لعب دور “الدليل”، وهو دور يمكن لأي شخص عادي القيام به؟
الجمع بين هذين السؤالين يقود إلى استنتاج محتمل، وهو أن سلي كان العقل المدبر للحملة، بعيدًا عن إرادة الملك عبادة، الذي يبدو أنه لم يكن قادرًا على معارضة نفوذ وزيره القوي. وهذا قد يحمل في طياته دلالات أعمق حول دور الأنباط في هذه الحملة وتبعاتها السياسية والاقتصادية
فاز الوزير سلي بتحقيق مصالح شخصية بدلاً من مصالح دولته، فقد كسب ثقة الرومان إلى درجة أنهم قبلوا احتمالية اعتلائه العرش بعد عبادة، وربما كان هذا هدفه الأكبر. أو على الأقل، سعى ليكون ممثلًا للرومان في جنوب الجزيرة. وإذا صح ذلك، فإنه يؤكد إخلاصه في إنجاح الحملة الرومانية، حيث تشير أعماله إلى أنه حتى لو كانت دولة الأنباط تحتفظ بشيء من الاستقلال آنذاك، فإن ضمان سلي لمصالحه كان يعني ربطها بالتبعية لروما. وهذا يفسر إعجاب أغسطس به، إلى جانب لباقته وذكائه، كما يفسر غضب الإمبراطور عندما تولى حارثة، خليفة عبادة، الحكم دون استئذانه، إذ كانت تبعية الأنباط لروما قد أصبحت في نظر أغسطس أمرًا مفروغًا منه
لعب سلي دور السفير لبلاده في الخارج، وزار بلاط هيرودس الكبير، حيث وقع في حب سالومة، شقيقة هيرود، التي بادلته المشاعر نفسها. وفقًا ليوسيفوس، كانت سالومة متلهفة للزواج منه، فغادر سلي بترا إلى القدس مجددًا ليطلب يدها من هيرود، إلا أن الأخير اشترط عليه اعتناق الديانة اليهودية، فرد سلي قائلًا: “لو فعلت ذلك، لرجمَني قومي”، وغادر بلاط هيرود غاضبًا. انتهز هيرود هذه الفرصة ليتخلص من الإحراج، فزوج شقيقته لأول خاطب تقدم لها
يمكن تفسير تصرفات سلي تجاه هيرود لاحقًا على أنها نتيجة لإخفاقه في الزواج من سالومة، حيث اتسمت مواقفه بالكيد والوقيعة. على سبيل المثال، عندما سافر هيرود إلى روما عام ١٢ ق.م، اندلعت ثورة في منطقة اللجا، التي كانت تحت سلطته. ورغم أن ضباطه تمكنوا من إخماد التمرد، لجأ أربعون من قادته الهاربين إلى سلي، الذي رحب بهم وشجعهم على الإضرار بمملكة هيرودس. وردًا على ذلك، رفع هيرود القضية إلى حاكم سورية وحاكم بيروت، مضيفًا إلى دعواه أن سلي اقترض منه مالًا ولم يرده. فصدر الحكم ضد سلي، لكنه لم يمتثل، وسافر إلى روما ليعرض قضيته على أغسطس
ربما خلال هذه الرحلة، توقفت سفينته في ملطية، حيث ترك نقشًا باللغتين اليونانية والنبطية يمجد فيه الإله “ذو الشرى” شكرًا على سلامته، كما لم ينسَ الإشادة بملكه عبادة. في غيابه، وبموافقة حاكم سورية، شن هيرود هجومًا على بلاد الأنباط، مستهدفًا حصنًا يأوي الثائرين. رد الأنباط بإرسال جيش بقيادة رجل يدعى “نقيب”، لكن هيرود انتصر، وقتل القائد وأربعة وعشرين من رجاله، فيما هرب بقية الجيش. وعندما وصل الخبر إلى سلي، سارع بإبلاغ أغسطس الذي أغضب من تصرفات هيرود، فرفض استقبال سفرائه، بينما حظي سلي بمكانة وإعجاب لدى الإمبراطور. كتب سلي إلى بترا ناصحًا عبادة بعدم تسليم الثائرين أو رد القرض والمال. لكن هل وصلت هذه الرسالة وعبادة ما يزال حيًا؟

الإله النبطي ذو الشرى
مهما يكن، فقد بلغ سلي نبأ وفاة عبادة أثناء وجوده في روما، ليعلن حارثة ملكًا من بعده. أصيب سلي بخيبة أمل، إذ يبدو أنه كان يطمح إلى العرش، في حين غضب أغسطس لأن حارثة لم يستأذنه قبل تولي الحكم. حاول حارثة استرضاء أغسطس برسالة اتهم فيها سلي، مدعيًا أنه أمر بتسميم عبادة. دعم نيقولاوس الدمشقي، المؤرخ ورسول هيرود، هذه الادعاءات، مما أثر في نظرة أغسطس إلى سلي، حتى اقتنع أخيرًا وأقرّ حارثة ملكًا
أضاف نيقولاوس أن سلي كان سبب الخلاف بين هيرود وأغسطس، وأن كل ما قاله عن هيرودس لم يكن سوى أكاذيب. وعندما طلب أغسطس منه توضيحًا حول حملة هيرود على بلاد الأنباط، أجاب بما رواه يوسيفوس
وسأبين أولاً أن التهم التي بلغتها لا يصح منها شيء أبداً أو أن ما يصح منها قليل جداً، إذ لو كانت صحيحة لازداد غضبك بحق على هيرود . أما القول بالجيش المزعوم الذي قاده هيرود فذلك لم يكن جيشاً وإنما جماعة أرسلت لتطالب بدفع المال، ولم يرسل المال على التو، بحسب ما يقرره العقد، بل إن سلياً كثيراً ما حضر عند ساترنينس وقولومنيوس حاكمي سورية، وحلف آخر مرة في بيروت يسعدك ويمنك أنه سيدفع المال، ولا بد، في خلال ثلاثين يوماً، وأنه سيسلم الهاربين الذين آواهم في بلده. ولما لم يفعل سلي شيئاً مما وعد به جاء هيرود إلى الحاكمين، واستأذنهما في الحصول على المال فأذنا له، وبعد لأي غادر بلاده على رأس عصبة من الجند لتحقيق تلك الغاية. وهذه هي كل الحرب التي يتحدث عنها هؤلاء القوم بتفجع ، وهذه هي قصة الحملة على بلاد العرب، وكيف تدعى حرباً حين أذن بها حاكمان من حكامك ، وسوعتها العقود المبرمة، ولم يجر تنفيذها إلا حين دنس اسمك يا قيصر مثلما دنست أسماء سائر الأرباب؟ وها هنا موضع الحديث عن من يسمون الأسرى كان هناك لصوص في الطرخونية (اللجا) وكان عددهم أول الأمر لا يزيد عن أربعين. ولكنهم زادوا عدداً فيما بعد. وقد نجوا من عقاب كان هيرود يريد أن ينزله ولجأوا إلى بلاد العرب، فتلقاهم سلي وزودهم بالطعام ليعم بهم، أذاهم بني البشر، ومنحهم موطناً يحلونه وكان له هو نفسه نصيب مما يكسبونه بالتلصص. ومع ذلك فقد وعد بتسليم أولئك الرجال، وحلف على ذلك بالايمان نفسها التي أقسم بها أنه سيرد الدين في الموعد المحدد. وهو لا يستطيع أن يثبت أن أي شخص عدا هؤلاء أخرج من بلاد العرب في هذا الوقت، بل لم يخرج كل هؤلاء وإنما عدد منهم لم يستطع التواري والاختفاء. وهكذا ترى أن الفرية حول أخذ أسرى وهي قرية صورت على نحو بشع، ليست أقل تلفيقاً وكذباً من قرية الحرب، وقد جرى تزويرهـا عمداً لتثير غضبك، واسمح لي أن أؤ كد بكل يقين أنه حين هاجمتنا قوات العرب وسقط واحد أو اثنان من جماعة هيرود صرعى، لم يفعل هيرود شيئاً سوى الدفاع عن نفسه، وعندئذ سقط ونقيب قائدها قتيلاً، وقتل معه ما لا يزيد عن خمسة وعشرين، إلا أن سلياً يجعل كل واحد من القتلى مائة، فيقدر أن عدد القتلى كان ألفين وخمسمائة
عاد سلي إلى بترا وهو خائب، ويقال إنه نظم سلسلة من الاغتيالات التي راح ضحيتها عدد من أعيان الأنباط، كما قيل إنه حاول اغتيال هيرودس نفسه. وعلى الرغم من أنه لا يعرف إذا كانت هذه الأخبار صحيحة أم لا، فإن عودته إلى روما في سنة ٦ ق.م، لم تؤدِ إلى تحقيق آماله في الحصول على رضا أغسطس، ففشل في تقدير الأمور بشكل صحيح، مما أدى إلى إصدار الإمبراطور أمرًا بقتله، ليقطع رأسه على يديه، ليوافيه الموت في عام ٤ ق.م
بعدها قسم هيرودس مملكته بين عدة ورثة، حيث حصل أرخيلاوس على نصف مملكة اليهودية، في حين نال فيليب مناطق اللجاة وحوران والبثنية، أما أنتيفاس فكانت نصيبه منطقة الجليل وشرق الأردن، بينما أضيفت غزة وجدر وهبوس إلى ولاية سورية
وقد طغت الأحداث الخارجية خلال فترة حكم عبادة، وكذلك معظم فترة من سبقوه، على ما نعرفه عن تاريخ الأنباط. ويرجع ذلك إلى أنه لم يكن هناك من يكتب تاريخ الأنباط، فبقيت معظم أخبارهم تسربت عبر علاقاتهم مع جيرانهم
وفيما يخص نقد عبادة، فقد أصدر خلال فترة حكمه نوعين من النقود. الأول كان في بداية حكمه، ويسمى “النقد البطلمي” الذي كان يزن نفس وزن النقد البطلمي، وكان أحد وجهيه يحمل صورة رأس عبادة، بينما الوجه الآخر يحمل رسمًا لصقر. أما النوع الثاني من النقود فيسمى “النقد اليوناني”، وكان وزنه أربعة غرامات ونصف، وقد صدر بين السنة العاشرة والعشرون من حكمه. وكان أحد وجهيه يحمل رأس الملك عبادة، بينما الوجه الآخر كان يحمل صورة رأس الملكة والملك معًا. وعلى جميع هذه النقود كانت مكتوبة العبارة: عبادة الملك ملك الأنباط
مالك الأول (٦٠ – ٣٠ ق.م)
لا تتوافر لدينا معلومات دقيقة عن حارثة الثالث بعد حملة سقاورس، كما أن تاريخ نهاية حكمه غير مؤكد. ويعتقد الأستاذ إنو ليتمان أن حكمه انتهى عام ٦٢ ق.م.، مع وجود فجوة زمنية بينه وبين مالك، إذ لم يظهر تاريخ مؤكد إلا في عام ٤٧ ق.م
يقدر أن مالك الأول بدأ حكمه بعد حارثة، وكان القنصل الروماني لسوريا آنذاك أولوس غابينيوس، الذي خاض عام ٥٥ ق.م. معركة ضد ملك نبطي لم يذكر اسمه. وإذا كان تقدير بداية حكم مالك صحيحًا، فمن المحتمل أنه الملك المقصود في الرواية. أما أسباب تلك المعركة، فتبقى غير واضحة نظرًا لتعدد الفرضيات، وربما كان الدافع الأساسي هو الطمع في المال، كما فعل سقاورس من قبل
ارتبط حكم مالك الأول بتطورات اليهودية (يهودا) والتغيرات السياسية في روما قبل قيام الإمبراطورية. وكان أنتيباتر الأدومي، بحكم علاقاته الوثيقة بالأنباط، هو المستشار الذي أثر على قرارات مالك وتحالفاته. وقد تزوج أنتيباتر من نبطية نبيلة، وأنجب أبناءً كان لهم دور بارز لاحقًا، مثل هيرودس الكبير وسالومة
في إحدى المعارك، قاد هيرودس جيشًا ضد الأنباط بالقرب من فيلادلفيا (عمان)، حيث هزم جيش الأنباط بقيادة الثيموس، وفر كثير منهم إلى صفوف العدو، بل وصل الأمر إلى حد إعلان ولائهم لهيرودس. ومع ذلك، فإن بعض تفاصيل هذه الرواية التي يوردها يوسيفوس تبدو غير منطقية، مثل طلب الأنباط المهزومين أن يصبح هيرود ملكًا عليهم، أو انتقالهم إلى قنوات على المنحدر الغربي من جبل الدروز
في أواخر حكم مالك، سعت ابنة هيركانوس إلى اللجوء إليه طلبًا لمساعدة والدها ضد هيرودس، خاصة بعد مقتل أنطونيو في أكتيوم وانتصار أغسطس أوكتافيان، الذي ظنت أنه سينتقم من هيرودس بسبب ولائه السابق لأنطونيو. غير أن الرسالة التي أرسلتها وقعت في يد هيرودس، فبعث بها لاختبار نوايا مالك، فجاء ردّه مرحبًا بهيركانوس ومن يرافقه. وكان ذلك ذريعة لهيرودس للتخلص من هيركانوس، لكن لم يتخذ أي إجراء ضد مالك، الذي اختفى ذكره لاحقًا من روايات يوسيفوس
توجد إشارات إلى مالك في بعض النقوش والنقود، منها نقش على أسكفة باب في قرية قرب بصرى، يذكر بناءً أقامه “سيدنا مالك”. كما وجدت نقود فضية تحمل صورته على أحد وجهيها، وعلى الوجه الآخر نسر باسط جناحيه، مع كتابة تؤكد لقبه ملك الأنباط
على الصعيد السياسي، بدأ أنتيباتر تحالفه مع يوليوس قيصر عام ٤٩ ق.م.، وأقنع مالك بدعمه ضد حاكم مصر البطلمي، فكافأ قيصر أنتيباتر بتعيينه حاكمًا على اليهودية، ما منح الأنباط جارًا حليفًا. لكن بعد اغتيال قيصر عام ٤٤ ق.م.، دخل البارثيون اليهودية، ما دفع هيرود للفرار إلى بترا، حيث لجأ إلى مالك، لكن الأخير رفض حمايته نزولًا عند رغبة البارثيين. حين غير مالك موقفه، كان هيرودس قد غادر إلى روما، حيث عينه الرومان ملكًا على اليهودية وأمروه بالقضاء على البارثيين وحاكمهم هناك
بعد ذلك، ظهر أنطونيو في المشرق تحت تأثير كليوباترا، التي طالبت بضم مملكتي اليهودية والنبطية إلى نفوذها. ورغم رفض أنطونيو طلبها، منحها جزءًا من الساحل الفينيقي ومزارع البلسم قرب أريحا، التي كانت تحت سيطرة هيرودس. كما كلف هيرودس بتحصيل أموال من الملك النبطي لصالح كليوباترا. وعندما تأخر مالك في الدفع، ضغطت كليوباترا على أنطونيو ليأمر هيرودس بشن حرب عليه
بدأ هيرود حملته بغزو حوران، وحقق انتصارًا أوليًا، لكنه هزم لاحقًا عند قنوات. طلب الصلح من مالك، لكن الأخير، في خطوة غير معتادة، قتل رسله، مما أثار الشكوك حول طموحه في الاستيلاء على الحكم
وبهذا، تظل فترة حكم مالك الأول متشابكة مع الصراعات الإقليمية، والتحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة خلال العصر الروماني
المراجع
عزام أبو الحمام المطور، الأنباط تاريخ وحضارة، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان – الأردن
إحسان عباس، تاريخ دولة الأنباط، دار الفجر للنشر والتوزيع، ٣٠ ديسمبر ١٩٩٨
Strabo: The Geography of Strabo, (The Loeb Classical Library), Cambridge,mass, 1961